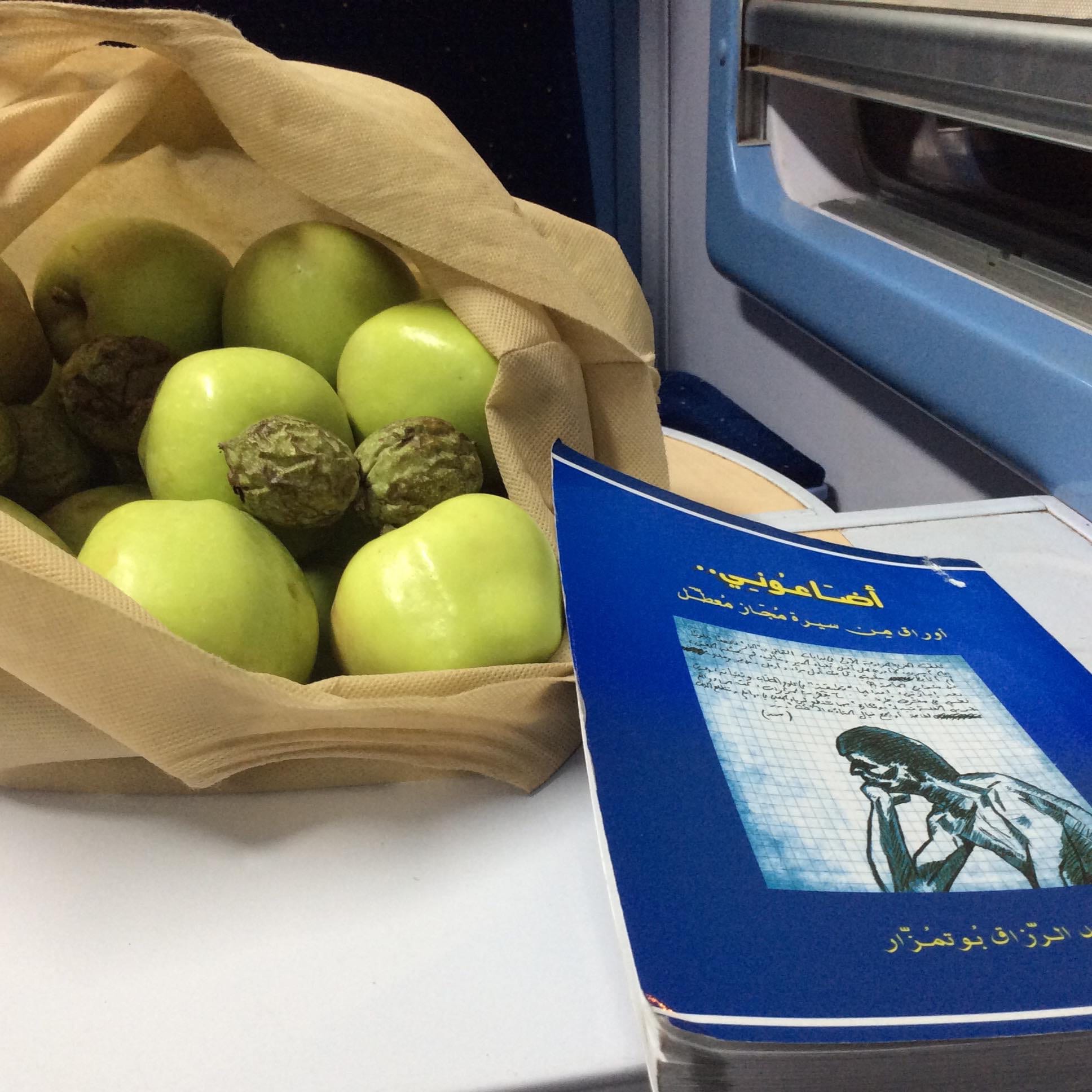عبد الرزاق بوتمزار
ح. 112
حين يحُلّ العيـد..
خالد الفاري لوحده عالَمٌ كامل وحكايا بالعشرات كلَّ يوم، كلَّ ليلة. لا يتوقف جدولُ استعمالِه الزّمنيّ لليوم عند العمل وتوفير بعض الدّراهم البيضاء لأيام سوداءَ كثيرة تتربّص. لا بدّ لرأسه الصّغيرة أن تدور، بعيدا عن انشغالاتنا “الفقيرة”، كما كان يقول حين يُعايِن حرصَنا اليوميَ على العمل. “لأجلِ هذا أكره أن يكونَ لي أصدقاء فقراء”؛ يقول خالد، إذا جمَعنا موقفٌ يظهر فيه أنّنا نحتاج إلى مُساعَدة منه في أمرٍ ما، رغم قلة المواقف التي قد تحتاج فيها مُساعَدة من شخص مثل خالد الفاري!
حين نلتقيه، أخيراً، ونلومه على أنه خذلنا مع موظف الجمعية بعد أن لم يُحْضر المبلغَ الأسبوعيَّ في الموعد المُتفق عليه، يُطلق ضحكته المُجلجِلة ويشرع في التّبرير. لمْ يكنْ يهُمّ ما يقول. الجميع يعرفون أنّ الجزءَ الغالبَ في كلامه لا يعدو كونه ادّعاءاتٍ وافتراءات؛ لكنْ علينا، رغم ذلك، أن نستمع إلى تبريراتِه المُضحكة. كنّا نعرف ما تفعل القنّينة بمَن يُطاردُها يومياً ولا تستطيع رأسُه أن تدور ما لم يشربِ “العصيرْ”، كما كان يسمّيه، كلّ ليلة. أما إذا اضطرّتْه ظروفٌ ما إلى احتساء “القاتِلة” فتلك حكاية أخرى.
كان خالد، ببلْيته تلك، يضرب كلَّ مُحاوَلاتنا أنْ نحترمَ التزاماتِنا وتعهّداتنا أمام الموظف العابس، ونبدو مثل مواطنين صالحين في عينِ مُؤسَّسته الجشِعة، التي تحلُب جيوبَنا في منتصَف كلَّ أسبوع، غيرَ عابئة بتقلباتِ السّوق ولا بتقلبات رأس خالد أو رأس غيره من أفراد المجموعة. وحين تدوخ رأس خالد الفاري أكثرَ ممّا ينبغي في الليلة التي تسبق يومَ الدّفع نكون أمام خيارَين لا ثالثَ لهما، إنْ نحن أردْنا أن نمضيّ اليومَ بلا “شُوهة” في ذلك الشّارع الخلفيّ. يقضي ليلته دائخاً أمام قنينته في مكانٍ ما وعلينا، نحن بقية عناصر المجموعة، أن نُعلنَ حالة استنفار في الحيّ كله بحثاً عنه كي يتكرّم علينا بدفع ما في ذمّته لموظف الجمعية. الحلّ الثاني: أن نجمع بقية المبلغ تضامناً في ما بيننا ونَستخلصَه منه في ما بعدُ، إنْ نحنُ عثرْنا له على أثر قبْلَ موعد الدّفع في الأسبوع المُوالي، طبعا. وحين كان خالد يغيبُ أسبوعين كاملين تعُمّ شكاوى عناصر أفراد المجموعة الشّارعَ وتصير مكتبتي الصّغيرة مكاناً للتشكّي وأيضا للتشفي.
حين كان يفعلها بنا ويُمرّغ كرامتنا في التّراب أمام قدمَي ذلك الموظفِ البئيس، يغيب بقيةَ اليوم عن دكانه وعن الحيّ كله. لا نراه إلا في اليوم التالي، أو بعد أيام أحياناً. ولن يجدَ أدنى حَرَج، كعادته، في إعادةِ أسطوانة تبريراته التي لا يمَلّ من ترديدها؛ ولو أنه يعرف أنْ لا أحدَ فينا سيُصدّق أيّ كلمة ممّا يقول. في ما بعدُ، سيَتشفّوْن وهُم يقولون إنهم بحثوا عنه في كلّ مكانٍ ولمْ يجدوه، بما في ذلك بيته، الذي دقوا بابه أكثرَ من مرّة؛ إلى درجة أنّ زوجته وابنتيه الصّغيرتين احترْن في أمر كلّ ذلك الإلحاح في طلبه.
كانت رؤوسُنا أجمعين تحتاج أن تدور، بين فينة وفينة. لمْ نكن بكلّ الثبات الذي يظنّنا عليه خالد الفاري، لو يدري. بيدَ أنّ دورانَ رؤوسنا ودوخاتها لمْ تكنْ مُتطلّبة بالقدْر الذي يجعلنا لا نظهر في دكاكيننا إلا بعد أن تمرّ عاصفة موظف الجمعية، بوجهه العابس مثل معطفه الأسود، الذي لا يُغيّره أبدا.
في أوقات أخرى من العام، ينقلب العبوسُ المُستبدّ بالوجوه ابتسامات وضحكاتٍ مُنطلقةً. يبيع التّاجر ويخيط الخياط وينشر النجار ويقصّ الحلاق. يفيضُ الشّارع الخلفيّ رواجا مفاجئا. يصير خالدُ آخرَ مَن يغادر محله وأولَ من يلتحق. قد صارتْ لديه الآن طلباتٌ كثيرة لقفاطينَ وتْكاشْط وجلابيب، من كلّ الأحجام والأذواق والأثمان. إنه أحدُ الأعياد في الأفق.. شكرا يا عيدُ، جعلتَ الخيرَ يفيض إلى الحدّ الذي لم نعدْ معه مُلزَمين بالبحث عن خالد في الأماكن الخبيئة كي يدفع ما في ذمّته لصندوق المُؤسَّسة الجائع.
تكتسي المدينة ثوبَ الفرح، مُتناسية كلَّ ما ألحقتْ بالأبناءِ من أعطاب (وأين بين حواضرنا المُرَيَّفة مدينةٌ تَسأل عن حالِ أبنائِها في هرولتها في عالم مُهروِل؟)..
يَتّشحُ الجبلُ من خلف الأسوار العتيقة ببياض ثلج الشّتاء أو يعلوه صفاءُ شمس الصّيف. تزهو مراكشَ وإلى الآفاق البعيدة تحلّق النظراتُ. تتطلع الأحلام إلى ما بعدَ المَدَيات. يُواصلُ تُجّار المدينة بيعَها للبرّاني، فيما تحتفي الأحياءُ الخلفية بهيجةً بالمُناسَبات والأعياد. تمتلئ جيوبُ الفقراء وبطونهم وتدور الرّؤوس وتدوخ فرَحاً بالعيد. وفي الخلاءِ كان الشّاعرُ فيّ يجد ملاذا هادئا من ضجيج نهارات الشّوارع الخلفية في أيامِ الرّواج وازدهار التّجارة.
مُرّاكش ليلاً.. لا أفضلَ من الليلِ وقتاً في حاضرة ابنِ تاشفين، خُصوصا في أيام الخريف والشّتاء، حين تَفرُغ من البشر. كنْ وحيداً في ليل مُرّاكش تَصرْ من سلاطين الزّمان. سرْ وحدَك في الحدائق وقربَ أسوار التاريخ وانتبهْ، قد تهمس لك أنّك تسيرُ في تراب أحسن جُغرافيا. أمّا حين تصادف خطواتِك قطراتُ الغيث الخفيفة، تنساب على الجسد المُثخَن جراحا وذكرَيات حُلْوات، فافتحْ دفاترَك وتابعْ انسيابَ القصيد، صرْ أنتَ الشّاعر، صرْ أنتَ الفارس في ليل فريد، تحت أسوار المدينة التاريخية.
كنّا نلتقي هناك صدفةً في أحيان كثيرة.
-ليلُ هذه الحمراء نقطةُ استرجاع لذكريات بعيدة. أن تعيش هنا في هذي المدينة معناه أن تستقلّ من الحياة نهارا وتعيشَ في الليل. لا تستطيع أن تُواصلَ العيشَ هنا دون فُرص للاستمتاع بليل المدينة وقد خلتْ من البشر..
يقولها عبد اللطيف الحشادي وهو يرفع يديه في الهواء، كما لو ليُعانقَ القطرات الخفيفة، ثمّ يُتابع، نافثاً دخان سيجارته من فمه ومن ثقبَي منخره، بوجهه الطفوليّ كوجه شاعر:
-لا أُحبّ هذي المدينة إلا حين أكون فيها وحيدا ولا أصادف في مُحيط هذي الحدائق أحدا؛ إلا وقد نامتِ المدينة ونام سكانُ المدينة!
-لستَ وحدَك في ليلِ مراكش؛ ليس جميعُ قاطنيها ينامون في العاشرة كلما ظهرتْ أولى قطرات الخريف!
كنتُ أقول له، وأنا أغيظه بإشاراتي وحركاتي وأذكّره بأنّني، أيضا، من عُشّاق المدينة حين يلُفّها السّكونُ والغيث. نُشعل سيجارتيْن إضافيتين ونبدأ جولتنا الليلية وقد عمّ المكانَ سكونٌ لا يكسره سوى صوت الرّياح بين أوراق الأشجار. يصيرُ كلّ الفضاء لنا وحدنا؛ قد نام سكانُ مراكش، قد هجعت أجملُ مدينة في أجملِ بلد!..