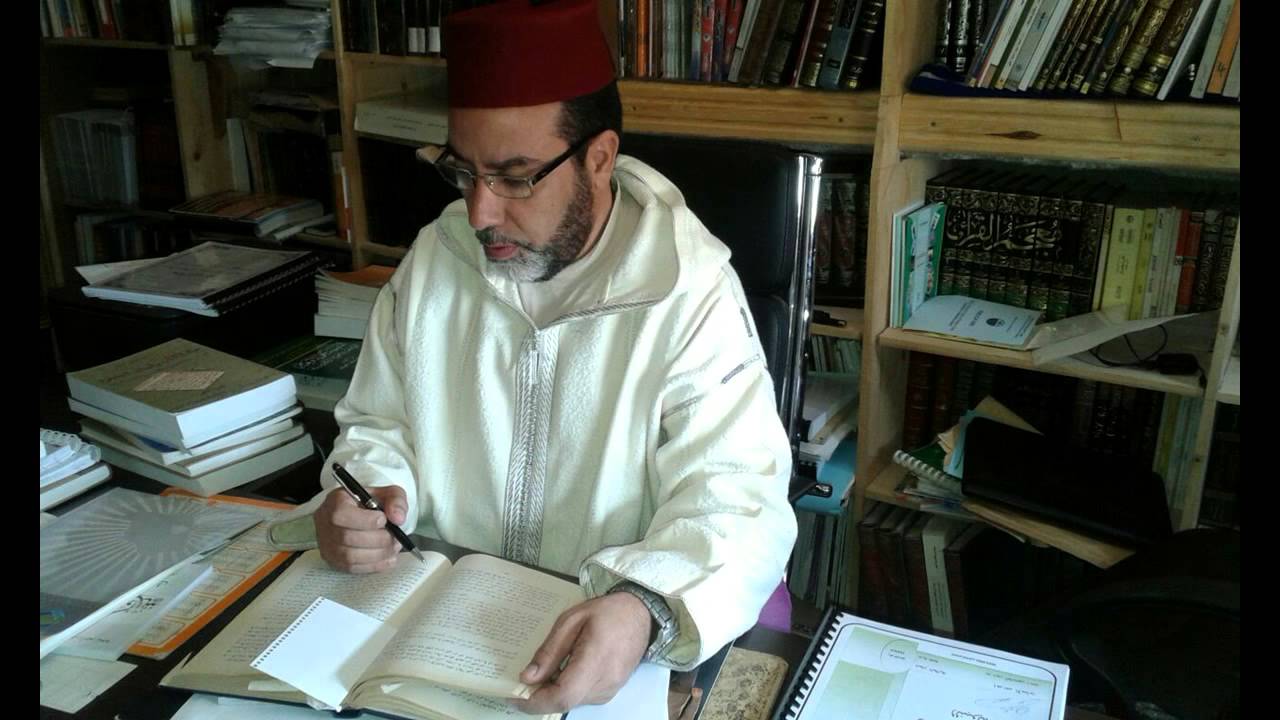لم يترجم للإمام أبي جعفر الداودي إلا فئة قليلة من علماء التراجم والوفيات، وأقدم من علمته ترجم له القاضي عياض (ت. 544 هـ)، ثم تلاه برهان الدين ابن فرحون (ت. 799 هـ)، فصاحب “شجرة النور الزكية”، فصاحب “معجم المؤلفين”.
تقديم -عبد الرزاق المراكشي le12
عُرف المغرب، منذ عهود، بإسلامه المعتدل، الذي يمتح من ينابيع قيَم التسامح والتكافل والتعاون التي طبعت الإنسان المغربي الأصيل، قائما على ركائزَ متينة تقوم على السجيّة المغربية، التي يسير وفقها كلّ أمر في الحياة بـ”النية“…
اخترنا لكم في “Le12.ma”وقفات مع ثلّة من الأقلام المغربية التي أغنت ريبرتوار الكتابات المغربية التي تناولت موضوع الإسلام المعتدل الذي انتهجته المملكة المغربية منذ القدم، والذي أثبت توالي الأيام وما تشهده الساحة السياسية العربية والدولية أنّ هذا الإسلام “على الطريقة المغربية” لم يكن بالضّرورة قائما على “الصّدفة (النيّة) بل تحكمه أعراف وقوانين وتشريعات واضحة المرجعيات والخلفيات وواعية تمامَ الوعي بأنّ الإسلام… (آية قرآنية) و”الإسلام دينُ يُسر وليس دين عُسر” وأنْ “ما شادّ أحدَكم الدين إلا وغلبه“.
في هذه المحطة الفكرية سنقرأ معا مقالة للكاتب محمد زين العابدين رستم في مقالة عنونها بـ”أول شرح مغربي لصحيح الإمام البخاري“.
ونشير إلى أن هذه المقالات منشورة في الموقع الإلكتروني لمجلة “دعوة الحق“.
أول شرح مغربي لصحيح الإمام البخاري.. “النصيحة في شرح البخاري” لأبي جعفر الداودي محمد زين العابدين رستم
أحلّ المسلمون كتاب “الجامع الصحيح” للإمام محمد بن إسماعيل البخاري( ت. 256 هـ) من أنفسهم محلا كريما، وأنزلوه بينهم منزلة رفيعة، فأقبل عليه طلاب العلم النبوي حفظا لمتونه، ووعيا لنصوصه، كما اعتنى به العلماء عن اختلاف طوائفهم ومداركهم، فرووه بأسانيد متصلة إلى جامعه، ورحلوا الأيام الطوال والليالي الطوال في تحصيل ذلك، وعقدوا مجالس الإملاء والتدريس في المساجد والمدارس ودور الحديث، للإملاء منه، والإجازة به.
وعني خلق كثير من العلماء بهذا “الجامع الصحيح” فأقبلوا عليه لاستخراج ما أودعه جامعه فيه من دقيق العلم، وعجيب المعاني، ولطيف الإشارات، وبدائع النكت، ومحاسن التصنيف والترتيب.
وشغل علماء الغرب الإسلامي بكتاب “الجامع الصحيح” فأقبلوا عليه شرحا لمتنه، وتعليقا على أسانيده، واختصارا لنصوصه، وبحثا لمشكلاته وألفاظا، وتعريفا برجاله ورواته، وإخراجا لدقائق فقه تراجم أبوابه“.
ومن مظاهر عناية علماء الغرب الإسلامية “بالجامع الصحيح” أن وجد فيهم “شرح قديم: يعد ثاني شرح الكتاب البخاري، وهو كتاب “النصيحة في شرح البخاري” للحافظ الإمام أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي.
وسنقوم في ما يلي بدراسة تحليلية لهذا الشرح وفق الخطة التالية:
أولا: التعريف بصاحب الشرح
لم يترجم للإمام أبي جعفر الداودي إلا فئة قليلة من علماء التراجم والوفيات، وأقدم من علمته ترجم له القاضي عياض (ت. 544 هـ)، ثم تلاه برهان الدين ابن فرحون (ت. 799 هـ)، فصاحب “شجرة النور الزكية”، فصاحب “معجم المؤلفين“.
على أن بعض هؤلاء ينقل عن بعض، والمصدر واحد وهو القاضي عياض في “ترتيب المدارك“.
وأما مترجمنا فهو: الإمام أبي جعفر أحمد بن نصر (2) الداودي الأسدي من أئمة المالكية بالمغرب، لم يذكر من ترجمه – ممن تقدم آنفا – سنة مولده، إلا أن القاضي عياض بن موسى قال:
إن أصله من “المسيلة”، وقيل من “بسكرة” كان بطرابلس، وبها أملى كتابه في “شرح الموطأ” ثم انتقل إلى تلمسان“.(2)
ولم يعرف عن الداودي أنه حمل عن أحد من المشايخ، قال ابن فرحون:
“وكان درسه وحده، لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور، وإنما وصل بإدراكه“.(3)
وعد القاضي عياض ذلك عيبا وغمزا فقال:
“بلغني أنه كان ينكر على معاصره من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد، وبقاءهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه:”اسكت لا شيخ لك”… يشيرون أنه لو كان له من يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقائهم، مع من هناك من عامة المسلمين، تثبيت لهم على الإسلام، وبقية صالحة للإيمان، وأنه لو خرج العلماء من إفريقية لما بقي فيها من العامة آلاف آلاف، فرجحوا خير الشرين“.(4)
ومع ذلك فقد وصفه غير واحد بالتقدم والرياسة في العلم، فقال فيه ابن فرحون:
” وكان فقيها فاضلا متقنا، مؤلفا مجيدا، له حظ من اللسان والحديث والنظر“.(5)
وحلاه الشيخ محمد بن محمد مخلوف بقوله:”الإمام الفاضل العالم المتفنن الفقيه“. (6)
وأشهر من حمل عنه: أبو عبد الملك البوني، وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد، وأبو علي بن الوفاء.(7)
لبث الإمام أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي بطرابلس زمنا ألف فيه “شرحه للموطأ” ثم انتقل إلى تلمسان، وبها توفي سنة 402 هـ، وقبره عند باب العقبة.
قال القاضي عياض:”وقرأت في بعض التواريخ أن وفاته سنة إحدى عشر، والأول أصح“. (8)
ألف الإمام الداودي كتبا متنوعة في الحديث والفقه والأصول والعقيدة، تشهد له بسعة الاطلاع، والشهرة في العلم، ومن بينها:(9)
1– كتاب النامي في شرح الموطأ؛
2– الواعي في الفقه؛
3– النصيحة في شرح البخاري: وهو من الشروح الأولى لهذا “الجامع الصحيح” وسيرد الكلام عليه مفصلا؛
4– الإيضاح في الرد على القدرية؛
5– كتاب الأصول؛
6– كتاب البيان؛
7– كتاب الأموال: وقد طبع بتقديم وتحقيق الأستاذ سالم شحادة، ونشر بعناية دار الثقافة -مركز إحياء التراث المغربي في الرباط.
ثانيا: تحقيق إسم شرح الداودي
ذكرت أكثر المصادر التي ترجمت للإمام الداودي شرحه البخاري وسمته:”النصيحة في شرح البخاري”، ومن بين هذه المصادر القاضي عياض، (10) وابن فرحون، (11) والقنوجي، (12) والشيخ محمد بن محمد مخلوف، (13) ومحمد رضا كحالة، (14) وأشار إليه من غير تصريح بالإسم القسطلاني، (15) والمباركفوري، (16) وحاجي خليفة. (17)
ثالثا: مكان وجود شرح الإمام الداودي
لم ينص أحد -ممن اهتمّوا في هذا العصر بتتبع مخطوطات وذكر أماكن وجودها- على مكان وجود شرح الإمام الداودي (18) حتى قال يوسف الكتاني:
أما عن شرح “النصيحة” فلا يعرف أثره إلى اليوم، وقد كان الظنون أنه من ذخائر خزانة القرويين، وقد بحثت عنه طويلا، وبمساعدة قيمها المرحوم العابد الفاسي، ومساعدون الذين أكدوا عدم العثور عليه، كما أنه لا يوجد مسجلا ضمن الكتب المفهرسة بها، ولا ذكر له في مختلف القوائم والفهارس المتعلقة بخزانة القرويين منذ “فهرس بل” سنة 1917 إلى اليوم، ولكنني أميل إلى وجوده إما بين الكتب التي لم تفهرس بعد، والتي أخذت الروضة تأكل بعضها، وإما بين مئات الكتب التي استعيرت من خزانة القرويين، وبقيت ضائعة عن المستعيرين إلى الآن، ومازلت آمل العثور على هذا “الشرح” النفيس. (19)
قلت: كتب يوسف الكتاني هذا الكلام منذ سنوات خلت، والمأمول في القائمين على خزانة القرويين، وعلى رأسهم محافظها أن يبالغوا في التنقيب عن هذا السفر النفيس، والكتاب الجليل، ضمن الكتب التي لم تفهرس بعد.(20)
ولقد حملني شوقي لشرح الإمام الداودي إلى جمع مادته المتناثرة في الشروح المتأخرة عنه، “كشرح” الكرماني (ت. 786 هـ)، و”شرح” الحافظ العيني (ت. 855 هـ)، و”شرح” القسطلاني (ت. 923 هـ) فتجمعت عندي مادة علمية كثيرة كتبت حولها هذه الدراسة.
رابعا: الكلام على منهج الداوي في الشرح
لما كان شرح الإمام الداودي مفقودا، استخرت الله عز وجل في جمع ما تناثر منه في الشروح المتأخرة عنه، والتي تكثر نقول أصحابها منه، ولقد أشرنا آنفا إلى أصحاب هذه الشروح.
وبعد استخراج النصوص، وجمعها من هذه الشروح، تبين ما يلي:
أ- كثرة المادة العلمية، التي تتكون من نصوص منقولة عن الإمام الداودي، أو مستفادة من كلامه، أو مشتملة على رأي ذهب إليه، أو استنباط حكم من حديث أو غير ذلك؛
ب- اشتملت كتب الأئمة الأربعة المشار إليها آنفا على أكثر من ستمائة نص ورد صحيح النسبة إلى الإمام الداودي؛ (21)
ج- تضمنت النصوص المستخرجة كلام الإمام الداودي على أغلب كتب “الجامع الصحيح”، وهناك كتب لا يوجد فيها للداودي ذكر، فما أدري أتكلم عليها في أصله أم لا؟ وقد تكون مما تكلم عليه، فأغفل ذلك كله هؤلاء الذين نقلوا عنه، والعلم عند الله تعالى؛
د- تتضح معالم منهج الإمام الداودي من خلال هذه النصوص المستخرجة، ويمكن أن نلم بها على النحو التالي:
1– مصادر الداودي في الشرح وموارده:
لم يسم الإمام الداودي في شرحه أحدا نقل عنه، أو استفاد منه،(22) ولعل مرد ذلك إلى ما ذكره القاضي عياض من “أنه لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه“.(23)
والذي يمكن تقريره -هنا- أن الداودي استعان -أثناء الشرح- بكتب كثيرة في اللغة والحديث والتفسير والفقه وغير ذلك؛
2– طريقة الداودي في الشرح والكلام عليها من وجوه:
الوجه الأول: اهتمام الشارح بالجانب اللغوي، وهذا أمر بين ظاهر لمن عاين النقول الكثيرة عنه، ويبرز هذا الاهتمام في أمرين اثنين:
1– شرح غريب الحديث النبوي
الأمثلة على ذلك كثيرة منها ” عند كلامه على قوله صلى الله عليه وسلم”… فيخرجون من النار قد امتحشوا” (24) قال: “امتحشوا: انقبضوا واسودّوا”؛(25)
2– ضبط المفردات
من ذلك عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم:”ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث…” (26) فقد حكى ابن قرقل(27) عن الداودي أنه ضبط الحنث بفتح المجحمة والموحدة، وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي.(28)
الوجه الثاني: عناية الشارح بالصناعة الحديثية، وذلك من عدة جوانب:
1– التنبيه على أوهام الرواة:
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: عند قول عاصم الأحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه – أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها“.(29)
قال الداودي: “هذه الرواية وهم، وقد أدخل بعض الرواة حديثا في حديث، إنما أتى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته منكشف فخذه، فجلس أبو بكر، ثم أتى عمر كذلك، ثم استأذن عثمان، فغطى النبي فخده، فقيل له ذلك، فقال: إن عثمان رجل حيي، فإن وجدني على تلك الحالة لم يبلغ حاجته”، وأيضا فإن عثمان أولى بالاستحياء كونه خنته فزوج البنت أكثر حياء من أبي الزوجة”؛ (30)
2– الكلام على صنيع البخاري في التراجم
وأكثر ما وقع له ذلك في مناقشة البخاري في إخراج الحديث في باب معين: مثاله قوله عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل، بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة، فنقرها…” الحديث(31). “حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء“.(32)
3– بيان المهمل
من ذلك: عند حديث أم عطية الأنصارية قالت: “دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال:…” الحديث.(33)
قال ابن حجر: قوله ابنته: “حكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان”؛(34)
4– بيان سبب اختلاف الروايات
مثاله قوله عند حكاية الخلاف في ثمن الجمل الذي اشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر:(35)
“ليس لأوقية الذهب قدر معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهما، قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز، فالمراد أوقية الذهب، وأما من روى خمس أواق من الفضة، فهي تقدير قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيتاء…”؛(36)
5– التنبيه إلى أن الحديث أو طرفا منه ليس محفوظا
مثاله تعليقه على حديث نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:” إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا…”،(37) فإنه قال: “قول الليث في هذا الحديث:” وكانا جميعا إلى آخره، ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع، ليس كمقام ملك ونظرائه“.(38)
الوجه الثالث: العناية بالاستنباط وبيان فقه الحديث، وفيه:
1– استخراج الأحكام، وبيان فوائد الحديث، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، نسوق منها مثالا واحدا.
في كتاب الغسل: عند قول عائشة رضي الله عنها:”كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إنماء واحد …”، (39) نقل الحافظ ابن حجر عن الداودي أنه استدل بهذا الحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.(40)
2– مناقشة الآراء، وبيان الراجح مع ذكر الدليل:
في كتاب “الأذان” في “باب الكلام في الأذان” ذكر البخاري في الترجمة كلام سليمان ابن صرد في أذانه، ثم ساق حديث ابن عباس، وكلامه مع المؤذن وأمره له بأن ينادي:”الصلاة في الرحال”. فعلق الداودي على ذلك بقوله: “لا حجة على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل”؛(41)
3– توجيه معاني الأحاديث:
مثاله عند شرح حديث: “إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا“. (42)
قال الداودي: “اختلف في قوله: “شرقوا أو غربوا”، فقيل إنما ذلك في المدينة، وما أشبهها كأهل الشام واليمن، وأما من كانت قبلته من جهة المشرق أو المغرب، فإنه يتيامن أو يتشاءم”؛ (43)
4– حكاية مذهب الإمام مالك وتقريه والدفاع عنه
وهذا ليس بالأمر الغريب، فقد كان الداودي من كبار المالكية، الذين تصدوا لشرح “موطأ الإمام المالك“.
ولبيان أثر فقه مالك في شرح الداودي نسوق المثال التالي:
في شرح حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله“.(44)
ذكر الحافظ ابن حجر اختلاف العلماء في جواز الزيادة على العشر، ثم قال:” وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر…” واعتذر الداودي فقال:لم يبلغ مالكا هذا الحديث، فكان يرى العقوبة بقدر الذنب“.(45)
خامسا: القيمة العلمية للنصيحة في شرح البخاري
اشتهر الداودي بين أهل العلم بكونه محدثا فقيها أصوليا، ثم بكونه من أوائل شراح “صحيح البخاري”، بل هو أول شارح مغربي “للصحيح” على الإطلاق، وثاني شارح “للصحيح” بعد الإمام الخطابي (ت 388هـ).(46)
ولقد صار شرحه بعد وفاته عمدة للشارحين الذين أتوا بعده، وينقلون من درره، ودقيق علمه، وممن استفاد منه عبد الواحد ابن التين السفاقسي (47) والقاضي عياض (ت 544هـ)، وابن قرقول، والعلامة شمس الدين الركماني، والحافظ علاء الدين مغلطاي (ت. 792 هـ) في شرحه للبخاري المسمى “التلويح” والحافظ ابن حجر في “فتح الباري”، والبدر العيني في “عمدة القارئ” والقسطلاني في “إرشاد الساري“.
ونورد في ما يلي نماذج مما نقله بعض هؤلاء الأعلام:
أ- نقول ابن التين: وهي كثيرة متنوعة، نوه بها حاجي خليفة فقال:”.. وكذا أبو جعفر أحمد ابن سعيد الداودي، وهو ممن ينقل عنه ابن التين“.(48)
ونختار في ما يلي واحدا من تلك النقول من “كتاب الأشربة”، فقد قال ابن حجر: “ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا، فإذا أضيف إليه الآخر، أسرعت إليه الشدة، وهذه صورة أخرى”؛ (49)
ب- يقول القاضي عياض: ففي شرح الحديث: “الخيل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر… فأما الرجل الذي هي عليه وزر، فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام.. الحديث”. (50) قال ابن حجر: “وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده: ونوى بفتح النون والقصر..”؛ (51)
ج- يقول الحافظ علاء الدين مغلطاي: قال العيني تعليقا على قول البخاري عقب حديث: “وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه “نقل صاحب “التلويح” -يعني مغلطاي- عن الداودي أنه قال في آخره ليس بمسند، لأن بين أيوب وأنس رجل مجهول، ولو كان عن أبي قلابة محفوظا، لم يكن عنده لجلالة أبي قلابة وثقته، وإنما يكني عمن فيه نظر“.(52)
سادسا: نقد الداودي الشارح
تعقب الأئمة الشراح الداودي في شرحه “لصحيح البخاري” من عدة جوانب هي:
أ- اللغة: من ذلك في شرح الألفاظ الغربية: ففي شرح لفظ: “قشبني” الوارد في حديث طويل، (53) قال الداودي:”معناه:غير جلدي، وصورتي“.
فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله:”ولا يخفى حسن قول الخطابي”، (54) وأما الداودي فكثيرا ما يفسر الألفاظ الغربية بلوازمها، ولا يحافظ على أصول معانيها”؛ (55)
ب- فقه الحديث، واستخراج الحكم:” في “كتاب الجمعة”، باب قول الله تعالى:” فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فمن فضل الله“.(56)
قال ابن حجر: “قوله باب قول الله عز وجل: “فإذا قضيت الصلاة…” الآية: جنح الداودي إلى أنه علم الوجوب في حق من يقدر على الكسب، وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية، وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم، فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت، ليفرح عياله ذلك اليوم، لأنه يوم عيد”؛(57)
ج- الحديث: وفيه ما يلي:
1– في بيان المهمل أو صاحب القصة: ففي قصة شرب العسل، (58) جزم الداودي بأن حفصة هي التي شربته، فتعقبه الحافظ بن حجر بأن ذلك:”غلط، وإنما هي صفية بنت حيي، أو زينب بنت جحش”؛(59)
2– في رد الروايات الثابتة: ففي شرح حديث سعد أنه قال: “اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك، من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم“.(60)
قال ابن حجر: “وزعم الداودي أن المراد بالقوم بني قريظة، ثم قال في الرواية المعلقة: هذا ليس بمحفوظ، وهو إقدام منه على رد الروايات الثابتة بالظن الخائب، وذلك أن في رواية ابن نمير أيضا ما يدل على أن المراد بالقوم قريش، وإنما تفرد أبان بذكر قريش في الموضع الأول، وإلا فسيأتي في “المغازي” في بقية هذا الحديث من كلام سعد، وقال:”اللهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له” الحديث.
وأيضا ففي الموضع الذي اقتصر الداودي على النظر فيه ما يدل على أن المراد قريش، لأن فيه: “من قوم كذبوا رسولك، وأخرجوه” فإن هذه القصة مختصة بقريش، لأنهم الذين أخرجوه، وأما قريظة فلا“.(61)
3– في الكلام على الأسانيد: فعند شرح حديث علي رضي الله عنه:”يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان… الحديث“. (62)
تكلم الداودي على إسناده “فزعم أنه وقع هنا: “عن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم” قال: واختلف في صحبة سويد، والصحيح ما هنا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم“.
قال الحافظ بن حجر متعقبا ذلك كله: “كذا قال معتمدا على الغلط الذي نشأ له عن السقط، والذي في جميع نسخ “صحيح البخاري”: “عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت”، وكذا في جميع المسانيد، وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن علي، ولم يسمع سويد من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وقد قيل: “إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، والذي يصح أنه قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح سماعه من الخلفاء الراشدين، وكبار الصحابة، وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم“. (63)
سابعا- مخالفة مذهب الإمام مالك
من ذلك أن الداودي زعم عند حديث سلمان الفارسي، من أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب…”،(64) أن ولاء سلمان كان لأهل البيت، لأنه أسلم على يد النبي صلى الله عله وسلم، فكان ولائه له”، فتعقبه ابن التين بأنه ليس مذهب مالك قال “والذي كاتب لسلمان كان مستحقا لولائه إن كان مسلما، وإن كان كافرا، فولاؤه للمسلمين“.(65)
ولقد أكثر كل من جاء بعد الداودي من انتقاده كابن التين، والزين ابن المنير، والإمام النووي (ت. 676 هـ)، وغالب هذه الانتقادات حكاه الحافظ ابن حجر في “الفتح“.(66)
وبالجملة، فإن شرح الداودي “لصحيح البخاري” لحقيق أن يعنى به أهل العلم، بحثا عن أصله، وتنقيبا عن نسخه، وإخراجا لمتنه، وتنويها بصاحبه.
وجاءت هذه الدراسة لتلفت أنظار الباحثين إلى هذا العلق النفيس، والكنز الثمين، الذي اغترف منه الأعلام الكبار شرقا وغربا، وصاحبها لم يدع أنها وافية بالمقاصد التي أمل الوصول إليها.
كيف؟ وهذا الأمر لا يؤمن فيه العتار، ولا يجتنب فيه الشطط والخطأ والنسيان، لأن الأصل مفقود، والشرح غير موجود، حتى إذا ظهر ذات يوم، فتح باب الإصلاح والتقويم والاستدراك.