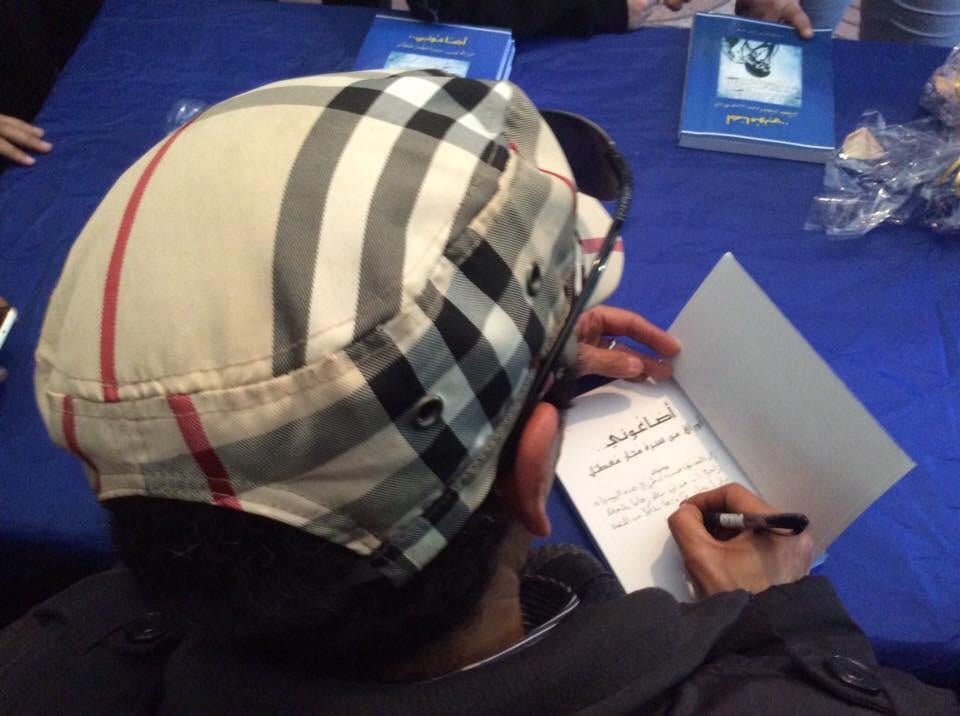عبد الرزاق بوتمزار
ح. 81
إيجازُ المقالْ في ما بين النّظرية والواقع من انفصالْ
تلقّيتُ الضّربة المُزدوجة الأولى في بدايات التحاقي بالدّار مراجعاً لغويا، مغلوباً على أمري، لا أدري هل أقبَل بغباء المُدير وتعاليه وجشعه المُخيف، أم أتأبّط حقيبتي وأرحل، بدون رجعة، عن شوارع العاصمة؟!
بعد إجازتين، إحداهما “تطبيقية” في علوم الكتاب وتقنياته، وجدتُ نفسي في مُفترَقِ طرُق أحلاهما يقطر بالمرارات، تحت سماء واقع مغربيّ الغلبةُ فيه لـ”بوشكارة”، مهْما تتنطّعْ كبرياءُ الجامعيّ في دواخلي وتتطلّع الذاتُ الطامحة أو يجمح خيال المُتأدّب الـْ”كُنت”..
وضعَ الواقعُ خيارَين على الطاولة أمامي: أقبلُ بعقدة محدودة الأجَل وبأجرٍ يُلامس حدود دناءاتٍ ارتُكبت دوماً وتُرتكَب في حقّ خريّجي جامعات البلد السّعيد ومَعاهده؛ أو أؤجّل موعدي مع الشّغل إلى فرصةٍ قد تأتي مُجدّداً وقد لا تلوح في أفق الانتظار.
تواطأتْ على طموحاتي دارُ النّشر إياها والدّولة، في شخص الـ”سّيوب”. وقّعتُ “العقد” المجحف وشرعتُ في عملي الجديد مُصحّحا؛ بينما يتأجّل، كما دائماً، تصحيحُ وضعي؛ مَن يُصحّح حالي أنا؟! ظلَّ السّؤال مُعلَّقاً.
التحقتُ بالدّار، في الطابق الثالث لعمارة في حيّ المحيط، مُراجعاً لغوياً أطارد هفوات أساتذتنا ودكاترتنا المُبجَّلين وشواردَ تعبيراتهم وهم يؤلّفون ما يساهمون به في صنع الثقافة في بلدٍ كان ليكون أجمَلَ لو أنهم “قارئون” بما يكفي، هؤلاء الذين يتحكّمون في صناعة ثقافته!
هل يكفي أن نملك بعضَ مالٍ (لا أحدَ يسألك من أين جئتَ به) وكثيراً من اللؤم والجهالة والأنانية ومُفكّرةً ملأى بالعناوين وأرقامِ الهواتف كي نصير ناشرين؟! سألتُني، وأنا أكوّن انطباعاً أوليا عن واقع الثقافة وصناعتها.
“تَفضّلَ” مُدير الدّار واكتفى باقتطاع 500 درهم “فقط” من المبلغ، الهزيل أصلاً، الذي كان من المُفترَض أن أتقاضاه عند نهاية كلّ شهر من العمل. نعمْ، يا سادة يا كرام (نْعاوْدها ليكم كِي لخْرافَة) كان السّيد المُدير، غير المُحترَم بتاتاً، يمتنع عن دفع نصف المبلغ الذي اتّفقَ مع الجهة الأخرى -في اتفاقنا الثلاثيّ- على دفعِه لي. كانت بنود اتفاق التشغيل تنصّ على أن يدفع الطرف المُشغّل ألف درهم، تضاف إليها ثمانمائة من الـ”سيوبْ”، ليكون مجموع راتبي الشّهري في الدّار ألفاً وثمانمائة درهم.. لكنّ سعادة المُدير وجد أنّ المبلغَ “أكبرُ”، رُبّما، من أن ينتهيَ إلى جيب “بّوفري” مثلي؛ ومن ثَمّ تفتّقتْ عبقريته عن أن يَحرمَني (علمتُ في ما بعدُ أنّني لم أكن الوحيدَ) من نصفه تقريباً.
استطاع ذلك “الناشرُ” تشغيلي بخمسمائة درهم عن كلّ شهر من العمل اليوميّ المُتواصل، مضافا إليه مبلغ ثمانمائة درهم التي تدفعها الـ”سّيوب”!.. لم يصدمْني “هُزالُ” ذلك الرّاتب، كما قد يُصدَم بعضكم الآن وهم يعرفون ذلك. في واقع الأمر، لم يصدمْني أيّ شيء وقد وقفتُ، منذ اليوم الأول، على جشع ذلك المُدير، سيّءِ الذكر، وعلى دناءة نفسه. بمقدوره إتيانُ كلِّ ما قد يخطر على البال من غرائب التصرّف والقولِ وما لا يخطر. شخصياً، ما همّني كثيراً ذلك الأجرُ الذي أتوصّل به بعد كلّ ثلاثين يوماً؛ وضعتُ نصْبَ عينيَّ أمراً واحداً: اختبار قـْرايْتي والمُحاضَرات وكلّ سنوات التحصيل الطويلة. كنتُ أريد أن أعرف هل أستطيع ربط جميع تلك النظريات، الكلاسيكيّ منها والمُوغِلِ حداثة -في غيرِ أمكنة الحداثة- بواقع الحال، على أرض الواقع؛ وكم كانتْ صلبةً، أرضُ الواقع، وقاسية!
-لا عليك؛ لا يَهُمنّك كم تتقاضى، ركّزْ على عملك فقط وانسَ أمرَ المصاريف، دعْ أمر ما قد تحتاج عليّ.
قال حسنُ، يوماً، لو تدري أيّها البئيس. كان شقيقي الذي أقمتُ معه خلال سنتَيْ الدّراسة الجامعية وبعدهما، خلال المدّة التي أمضيتُ في الدّار، قد حفّزني على الاستفادة، قدْر الإمكان، من التّجربة وألا أهتمّ بأمرِ ما قد ينقصني من دراهمَ لإنهاء الشّهر بغيرِ ثقوبٍ كثيرة في الجيب وفي الكرامة، مُصحّحا في دارٍ على أعتابها تُخنَق كلّ رائحة لأدبٍ وفكر!.. كان كلامُه الضّامنَ الوحيد لصبري على كلّ حماقاتك والجهالاتِ، أيّها المُدير المثيرة حالك للشّفقة، بينما تحسب نفسَك في مصافّ الأذكياء.. كم هي صغيرة أنفسُنا لو نستوقفها لحظاتٍ أمام مرآة الحقيقة، ولو مرّة واحدة في اليوم؛ لكنْ ليس لدى الجميع كلّ هذا الوقت لمُساءَلة الذات، حسب ما يبدو..
بتوالي أيامي في عمارة المحيط، في ذلك الزّمان البعيد من بدايات الألفية الجارية، ما عاد أمامي، بدَوري، كثيرُ وقتٍ؛ صرتُ، بِغضّ النظر عن التفاصيل، حلقةً في سلسلة تدور، منذ ساعات الصّباح الأولى، في عمليات مُترابطة لصناعة الثقافة في مملكة لو كان صنّاعُ ثقافتِها “قارْيِينْ” شيئاً آخرَ عير التّحرامياتْ والقوالبْ لكانت بحقّ الأجملَ بين بلدان العالَم!..