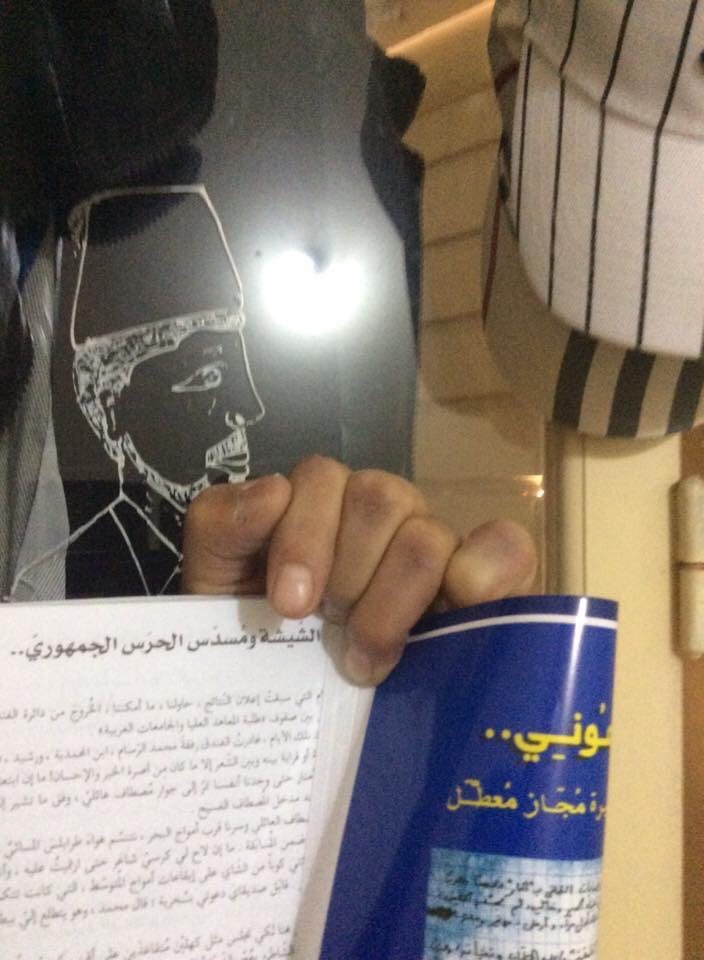عبد الرزاق بوتمزار
ح. 72
رسّام بلا ريشة في بلاد العجائب
بعد حادثة إشهار ذلك “الحارس”السّلاحَ الناري في وجه محمد داخل المُصطاف العائلي، لم نَعْدَم، رشيد وأنا، فرصا كثيرة للتفكّه على الرّسام المسكين، الذي لم تنفعْه جثته الضّخمة في صدّ الاعتداء ولم تُسعفه ذراعاه حتى في تنفيذ أوامر عنصر الحرس الجمهوري بأن يُنزلهما كما طلب منه وهو يتحدّث إليه. صرنالا نُفوِّت مُناسَبة لتذكيره بالحادث، ونحن نضيف إلى الحكاية بعضَ التّوابل حتى نزيد من غيظه وندفعَه إلى إصدار مزيد من التعليقات الخارجة عن السّطر التي اعتاد إتحافَ مَسامعنا بها كلما أفلحنا في إغضابه.
لم يستطعْ عقله أن يستوعب كيف ينتهي موقفٌ “عاديّ” كان خلاله يُردّد بعضَ الأهازيج الشّعبية، فرحا بشبابه، بأن يُباغته ذلك الحارس ويأمره ورفيقَه بالتوقف عن “جريمة” الغناء في أحد المُصطافات العائلية وسط عاصمة الجماهيرية، المحروسة ضدّ جميع الكبائر والبدَع، من قبيل الضّحك أو الغناء!
-طيلة خمس وعشرين سنة لم أرَ ولو مرّة واحدة مُسدّسا عن قرب؛ فكيف لا أفقد صوابي وقد ألصقَه ذلك الغبيّ بصدغي وهو يتوعّدُني بالويل والثبور بلغة لا أكاد أفهم كلمة واحدة منها؛ فكيف كنتما تُريدانني أن أتصرّف؟
-لكنه لم يطلب منك سوى أن تُنزل يديك وأنت تتحدّث إليه!
يقاطعه رشيد، وهو يغمزني بتواطؤ.
-يا ولدْ لعْديمَة كُن كنتِ أنتَ اللـّي حْط عْليك داكْ الفْردي كُن دْرتيها فحوايْجك، ماشي غيرْ تبقى هازّ يديكْ بحالي..
يُجيبه الرّسام وهو يخبطه بضربة على قفاه؛ فتعلو ضحكاتُنا ونحنُ نؤكّد للغليظ أنه ما عاد يُخيفنا، بجُثثه الضّخمة، بعدما شَلّت أوامرُ ومسدّسُ ذلك الأواكسي حركتَه إلى درجة أنه لم يستطع حتى أن يُنزل يديه ويُخرج نفسَه من ورطته، قبل أن يتدخّل رشيد ويُفهِم عنصر الحرس ذاك أنّهما غريبان عن البلد ولا يعرفان قوانين المُصطاف.
كانت تلك الواقعة الفريدة بمثابة القشّة التي قصمت ظهر الرّسام التّعيس، الذي جانَبه الحظ منذ اليوم الأول، حين تأخّر عن موعد الإقلاع ليجد نفسَه، بعد ذلك، يخوض غمار رحلة سيزيفية استطاع إتمامَها في ظروف أغربَ من الخيال ذاته. وفوق ذلك، لم ينفعْه قدومُه في شيء ما دام قد نسيّ لوحاته على رفوف طائرة لا يدري في أيّ سماوات حلّقت بعد أن جرّدته مما كان سيُعطي وُجوده بيننا معنًى. ثم يأبى حظه العاثرُ إلا أن يجلب له متاعبَ إضافية ما كانت، لغرابتها، لتخطر على بال.
أمضى رسّامُنا البدين الأيام القليلة التي فصلت بين الواقعة وبين عودتنا إلى المغرب، بعد انتهاء فاعليات المُسابَقة الأدبية، حزيناً، مهموما، يُجاهد لكتم غيظه، الذي كان يُفجّره، خُصوصاً في وجه رشيد وفي وجهي، كلما تماديْنا في تذكيره بوقائع تلك الأمسية المُضحكة. وبقدْر ما كان يستشيط غضباً وهو يروي لنا ما وقع، كنّا نخنق ضحكات الاستهزاء ونحن نُبدي له تعاطفا كاذبا ونُهوِّن عليه قائلَين إنّ الموقفَ، في عمومه، سخيفٌ ولا يستحقّ أن يشغل به بالَه، ما دام أنّ أيّاً منا قد يتعرّض لأمر مُماثل أو أفظعَ على أرض لا تكاد تخرج فيها أمورٌ عديدة عن دائرة الغرابة. والحقيقة أننا، بتندّرنا على المواقف التي تحدُث أمامنا أو نسمع عن وقوعها في تراب الجماهيرية وتحويلَها إلى مرويات نتسامر على إيقاع استرجاعها داخل إحدى غرف الفندق، كنّا فقط نحاول ألا نُصاب بلوثة أو مسّ جرّاءَ كل ّ”المُغْربات” التي أثثت مُجريات أيامنا العشرة في “بلادِ عجائبَ” حقيقيةٍ لا ندري أيَّ أحداث غرائبية أخرى تُخبّئ لنا فيها أقدارُنا اللئيمة.
بعد أن تنتهي جميع المواضيع التي تُشكّل مواد لتسامُرنا في ليالي طرابلسَ الخانقة، يأوي كلٌّ منا إلى فراشه، يفكر في ما مرّ به خلال يومه المُنصرم وفي ما ينتظره في اليوم المُوالي، في المُغامَرة المقبلة!
من جهتي، كان أمرٌ واحد فقط يسيطر على تفكيري، ما إن أتذكّره حتى أصابَ بالاكتئاب والإحباط: الطائرة الليبية التي علينا أن نستقلها ونحن عائدون إلى مطار تونس -قرطاج.. كانت “مصيرا” أسودَ كنت مستعدا لفعل أيّ شيء شريطةَ ألا أواجهَه؛ لكنْ ما كلّ ما يتمنى المرءُ يُدركه!