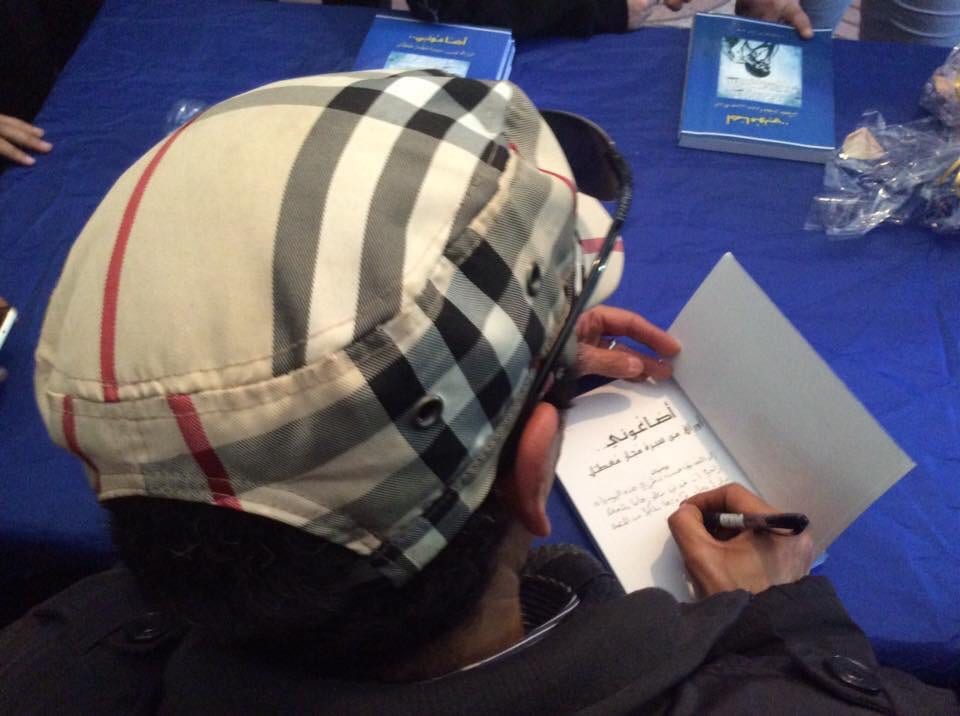عبد الرزاق بوتمُزّار
ح. 22
ودَخلنا الجامعة..
بعد عطلة صيفية أمضيْناها في تشمّم روائح الكونكورات حيثما فاحتْ وتعبئة طلبات المُشارَكة في مُبارَيات هنا وهناك، في محاولة يائسة لتفادي “خيار” الجامعة؛ لم يجد السّواد الأعظمُ منا بدّاً من الاستسلام للأمر الواقع وركوب “طوبيسْ لافاكْ”. ركبوا وركبتُ، مُكرَهين لا أبطالاً.
كلّ تلك الطوابع البريدية ونُسَخ شهادة الباكلوريا وبطاقة التعريف الوطنية وعقود الازدياد وشهادات السّكنى والحياة؛ ولستُ أدري ماذا أيضاً، التي يُطلب منا الكثيرُ منها في أيّ إعلان عن مباراة من تلك المبارَيات.. كلّ ذلك ذهب إلى غير رجعة. رُكنتْ كل تلك الأوراق والمداد في مكان ما داخل دهاليز ومكاتب إدارات ومُؤسسات عبر تراب المملكة دون كثير تفكيرٍ من أحد موظفيها في مصير أصحابها..
بعد أن ثقبتْ مصاريفنا الكثيرة جيوبَ آبائنا وأفراد عائلاتنا القادرين على الإنفاق، بقي باب واحدٌ لا يشترط لدخوله أكثرَ من شهادة “الباكْ” إياها؛ وتعرفون، طبعاً، أيَّ باب أعني..
تقع كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عياض، في الطرف الآخر لمدينة السّبعة رجال. وتحتلّ هذه الكليّة، إلى جانب كلية الحقوق، حيّزا كبيراً من منطقة شاسعة في “الدّاودياتْ”؛ الحيّ الذي أمضيتُ فيه جزءاً من طفولتي. هناك حطـّت الأسرة، في مطلع الثمانينيات، الرّحال بمنزل في الوحدة الرّابعة، غيرَ بعيد عن المبنى الجامعيّ، قادمة من قرية على مشارف مُرّاكش..
كلَّ صباح، كنّا نتدبّر بعض الدّراهم من أهلنا ونستقلّ الحافلة المزدحمة من ساحة المْصلّى في اتّجاه حجرات الدّرس الجديدة، التي صارتْ الواحدة منها تحمل اسم المدرّج.
فتحتْ أجواءُ الجامعة أعيُننا على مُعطيات جديدة وأنساق مُتقاطعة من المَدارك والأفكار وأحالتنا على عوالمَ يتوسّع فيها مجالُ الحرّية والتصرّف وتتضارب داخل رحابها زوايا النظر إلى الناس وإلى العالم..
كانت متابعة الدّراسة في شعبة اللغة العربية وآدابها قناعةً ذاتية ترسّختْ في ذهني منذ الأيام الأولى التي اكتشفتُ فيها متعةَ القراءة؛ الهواية التي انقلبت لديّ، وأنا أنتقل من كِتاب إلى كِتاب، ضرورةً من ضرورات الحياة. ولأنّ الكثيرين كانوا يعُدّونها مطية سهلةً يَسيرٌ ركوبُ قطارِها المغبون. كانت شعبة اللغة العربية وآدابها تعرف تسجيل المئات من الطلبة، المغلوبين على أمورهم؛ بَيْدَ أنّ بداية علاقتي بكلية الآداب اتّسمت بحالة من الارتباك جعلتني أسجّل اسمي، في البداية، خلافاً لكلّ التوقعات، في شعبة التاريخ والجغرافيا!
استغرب كثير من أصدقائي، كما استغربتُ بدوري لاحقاً، هذا الاختيار الغريب منّي؛ لكنْ لا أحد كان يعرف ما يعتمل في دواخلي المضطربة. كان ما جعلني أناور وأتخلى، مُكرَهاً، عن عشقي الأول (الأدب العربي) هو أنّ زميلا كان قد جاورني طيلة سنوات الثانوية، ظلّ يعتمد عليّ اعتمادا كلياً لضمان النجاح والانتقال، في نهاية الموسم، إلى القسم الموالي. كان الفكاك منه صعباً. وجدتُ في الانتقال إلى الجامعة فرصةً ممواتية لتحقيق هذه الغاية.
كان هو قد “سبقني” وسجّل اسمَه في شعبة اللغة العربية وآدابها؛ ما دفعني، أمام “حبّه ولهفته”، إلى البحث عن بديلٍ لـ”شُعبة مَن لا شُعبةَ” له في جامعاتنا المغربية، المسكينة. كان من أكبر المؤمنين بنظرية “مَن نقل انتقل ومَن اعتمد على نفسِه بقيّ في قسمه”.. من ثم، أقنَعَ نفسه بأنّ أسهلَ طريقة للاستمرار في الإخلاص لهذه المأثورة المُستحدَثة هي أن يظلَّ “لاصقاً” فيّ حتى ونحن في الجامعة!
لأجل “معاكسته” فقط، تخليتُ عن شُعبتي المُفضَّلة ورهنتُ مُستقبلي الدّراسي بـ”تخصّص” آخرَ من بين “التخصّصات” المُضحكة/ المُبكيّة، في آن، التي تقترحها جامعاتنا المُوقرة على قاصِديها من الرّاغبين في التعلم و”التحصيل”..