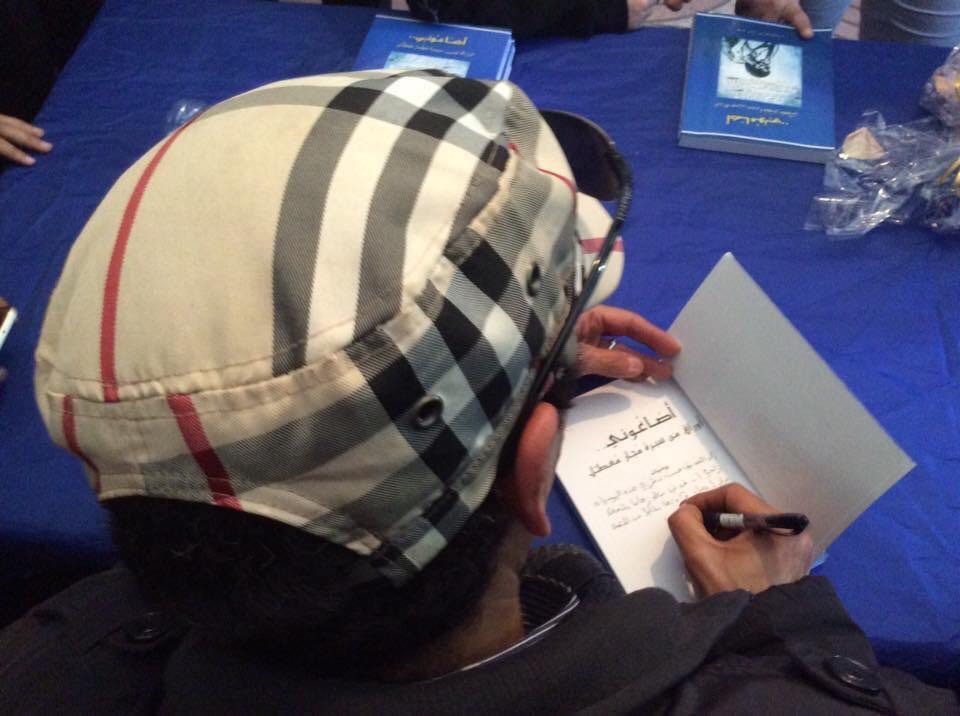عبد الرزاق بوتمُزّار
ح. 3
ميلادُ كاتب؟
وَلّد لديّ عشقي الكبير للمُطالَعة رغبةً في تجريب ذاتي في مجال الكتابة أيضا؛ بعد أن ظللت، سنوات طويلة، قارئا نهما يتعذر إشباعُ جُوعي المعرفيّ. طوّرتُ أسلوباً في الكتابة اعترف العديدُ من أساتذتي والمُهتمّين بخصوصيته وتفرّده. وكانت القصّة القصيرة الجنسَ الأدبي الذي عرفتُ كيف أعبّر فيه أفضل تعبير عن أفكاري وخيالاتي.
يومَ فاتح أبريل من 1995، وأنا في سنتي الجامعية الثانية، عرف أول نصوصي القصصية طريقه إلى النّشر على صفحات إحدى الجريدتين الرّائدتين آنذاك. كان يوماً مشهوداً بكل المقاييس.. هل استطاع كاتبٌ ناشئ، في أيّ مكان من العالم، أن يصف شعورَه وهو يرى اسمَه لأول مرّة على صفحة جريدة أو مجلة؟ إذا كان ثمّةَ من استطاع فِعْل ذلك، فأنا أُقرّ وأعترف: عاجز!
في ذلك اليوم، ابتعتُ ما كانت تسمح به ميزانيتي من نُسَخ الجريدة ورحتُ أوزّعها على جميع من صادفتُهم في طريقي من أصدقاءَ ومعارفَ؛ بعد أن أكونَ قد أحَلتُهم طبعاً على الصّفحة التي وضعتْ اسمي إلى جانب أسماء “الكبار”.
حملتُ الخبر السّار إلى والدتي، في مُحاوَلة لأنْ أجعلها تفهم، أخيراً، لماذا كنتُ أنزوي في غرفتي وحيداً في أواخر الليالي وأستهلك كلّ تلك الكمّيات من القهوة “الكحلة”..
غمرتني بدعواتها الجميلة. تهللت أساريرُها واتّسعت عيناها وشعّتا فرَحا. بدَا لي وجهُها طفولياً، كما في كلّ مرة حين تسمع خبراً مُفرحاً، رغم تجاعيد السّنين، التي بدأتْ ترسم على تفاصيله خطوطها.
لحظاتٍ بعد ذلك، قصدتُ السّوق الشّعبي حيث يشتغل والدي فأطلعتُه، بفرح غامر، على الخبر -الحدث. بعد أن هنّأني على حُسن صنيعي، طلب منّي أن أقرأ عليه النصَّ كاملاً.. لم يكن أمياً، بل فقيها يجيد القراءة والكتابة، لكنْ كان لتقدّمه في السن أحكامه غير المكتوبة. حتى خيط الإبرة في ماكينته “السّانجير” العتيقة كثيرا ما كان يطلب منّي أن “أنْظمه” له كلما حملتني صدفة ما إلى دكانته الصّغيرة.
والدي، ذلك الرّجل السّتيني، بقامته الفارعة وقسوته الظاهرة، التي طالما أذاقني منها الكثير، تحوَّلَ أمامي، في ذلك اليوم، إلى شخص آخر؛ تهلّلتْ أساريرُه وراح يتطلع إليّ بنظرات تفيض حنانا ورقة وفخرا، وهو يشجّعني بحركات مستحسنة على مواصلة القراءة -الحكي.
كان والدي، في شبابه البعيد، من أولئك الرّجال الذين دافعوا عن رُبوع الوطن، مُشتغلين بفاعلية وفي صمت، دون انتظار مقابل. عندما كانت أمّي تحكي لنا عن كلّ تلك المرّات التي كان زُوارُ اللّيل يأتون ليأخذوه إلى سُجون بعيدة لا أحدَ يعلم بها سواهم، أو عندما يلجأ إلى حِيلٍ ومَقالبَ عجيبةٍ -تُثير ضحكنا- ليُفلت من رقابة العملاء والمُخْبرين الذين كانوا يترصّدون خطواته عند كلّ ناصية، كانت تسكُننا نشوة لا تُوصَف لنيل شرف الانتساب إلى رَجُل مثله. وكان من جميل الصّدف، أيضاً، أنّ جريدة حزبه “العتيد” هي التي نشرتْ قصّتي الأولى.
قرأتُ عليه النصّ بنشوةٍ غامرة. كنت أعرف ما يعنيه له نشرُ قصّتي الأولى في جريدة حزبه؛ سمعها وكأنها قصّته التي لم يَكتبْ!